 |
| من فيلم "الطيب والشرس والقبيح" |
 |
| من فيلم "كلاب القش" |
كتابات نقدية حرة عن السينما في الحياة، والحياة في السينما............. يحررها أمير العمري
 |
| من فيلم "الطيب والشرس والقبيح" |
 |
| من فيلم "كلاب القش" |
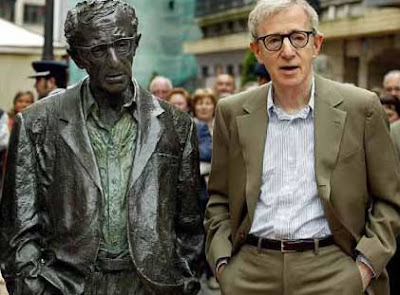
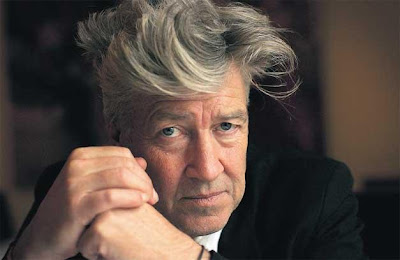

 فى رأيى أننا افتقدنا عمل شاهين الممثل الفذّ مع مخرجين كبار أكثر اعتدالاً من شاهين فى إدارة الممثل وأخصّ بالذكر تحديدا هنرى بركات وكمال الشيخ. لو عمل شاهين تحت إدارة هذين الكبيرين لشاهدنا روائع حقيقية . أرجو أن تعود الى فيلم اسماعيل ياسين فى الطيران لترى كيف اكتشف فطين عبد الوهاب فى شاهين قدرات كوميدية خطيرة خطفت الأضواء فى مشاهد قليلة من إسماعيل ياسين شخصيا.
فى رأيى أننا افتقدنا عمل شاهين الممثل الفذّ مع مخرجين كبار أكثر اعتدالاً من شاهين فى إدارة الممثل وأخصّ بالذكر تحديدا هنرى بركات وكمال الشيخ. لو عمل شاهين تحت إدارة هذين الكبيرين لشاهدنا روائع حقيقية . أرجو أن تعود الى فيلم اسماعيل ياسين فى الطيران لترى كيف اكتشف فطين عبد الوهاب فى شاهين قدرات كوميدية خطيرة خطفت الأضواء فى مشاهد قليلة من إسماعيل ياسين شخصيا. جلسة رائعة جمعتني في لندن أخيرا رغم البرد القارص، والأشغال الشاقة التي أقوم بها هذه الأيام، مع صديقين من أصدقاء الزمن الجميل: المنتج السينمائي الفلسطيني عمر قطان، والمخرج المعروف ميشيل خليفي.
جلسة رائعة جمعتني في لندن أخيرا رغم البرد القارص، والأشغال الشاقة التي أقوم بها هذه الأيام، مع صديقين من أصدقاء الزمن الجميل: المنتج السينمائي الفلسطيني عمر قطان، والمخرج المعروف ميشيل خليفي. مقالي عن فيلم "زنديق" أحد أفلام ميشيل خليفي الذي حصل على ذهبية مسابقة المهر للأفلام العربية الروائية الطويلة، أعجب ميشيل كثيرا.. وقال لي إنه وجد فيه الكثير مما كان في ذهنه فعلا أثناء كتابة وتصوير الفيلم، فقلت إنني لا أعرف ما إذا كان هذا حقيقيا أم لا ولكني عادة ما أعبر عن "رؤيتي" الخاصة للعمل السينمائي، واستقبالي الشخصي له، دون أي محاولة لتجميع "معلومات" مسبقة عن ظروف صنع الفيلم، وإنني آمل دائما أن يكون المقال النقدي تعبيرا عن علاقتي بالفيلم، وأن يكون أيضا قطعة "أدبية" لا تقل أهمية عن الفيلم نفسه، بل تتماهى معه وتدخل أحيانا أيضا، في سجال وجدل مع أفكاره.
مقالي عن فيلم "زنديق" أحد أفلام ميشيل خليفي الذي حصل على ذهبية مسابقة المهر للأفلام العربية الروائية الطويلة، أعجب ميشيل كثيرا.. وقال لي إنه وجد فيه الكثير مما كان في ذهنه فعلا أثناء كتابة وتصوير الفيلم، فقلت إنني لا أعرف ما إذا كان هذا حقيقيا أم لا ولكني عادة ما أعبر عن "رؤيتي" الخاصة للعمل السينمائي، واستقبالي الشخصي له، دون أي محاولة لتجميع "معلومات" مسبقة عن ظروف صنع الفيلم، وإنني آمل دائما أن يكون المقال النقدي تعبيرا عن علاقتي بالفيلم، وأن يكون أيضا قطعة "أدبية" لا تقل أهمية عن الفيلم نفسه، بل تتماهى معه وتدخل أحيانا أيضا، في سجال وجدل مع أفكاره.
بقلم: عماد إرنست
"كل شيء في النهاية فكاهة
وسأظل شيئا واحدا، وشيئا واحدا فقط، مُهرّج؛
وذلك يضعني على مستوى أعلى يفوق أي سياسي"
شارلي شابلن
غالباً ما يكون المهرج Clown بهلوانا سابقا، أي لاعب حبل أو ترابيز أو آكل نيران أو ممارس للعبة ما خطرة من ألعاب السيرك، ولكن، ونظراً لظرف خاص من الإصابة أو التقدم في العمر أو لظهور لاعب آخر يجيد ذات الوظيفة بطريقة أكثر ملائمة لأغراض استمرار الجذب، يتم استبداله موجهين إياه نحو إضحاك الجمهور بحيل وطرائف، جد جاذبة، وتقدم على فترات لتوفير إيقاع عام لبرنامج الليلة. إلا أنه، وفي حالة إستثناء خاص من هذا، وحين يكون هذا المهرج The Clown جزءا عضويا إستثنائيا من تاريخ السيرك ذاته؛ أي بمثابة خزين لذاكرة السيرك العضوية والثقافية، ويكون قد سبق له الظهور كلاعب ماهر وموهوب في ألعاب كثيرة من ألعاب السيرك السابق ذكرها، حينئذ، وحينئذ فقط، يوظف بإرادته ملكاته تلك التي تكون في إنتظار لحظة يتم فيها الإحتياج لها؛ إما بسبب إعياء مهرج آخر، أو لسقوط بهلوان لسبب ما؛ كخطأ غير متعمد من الغير، أو من الصدفة، أو من الغرور، أو من نسيان أو إهمال للحرفة!
لكنه، عندما يتقدم لتقديم هذه الفقرة، فهو يقدمها في ذات بذلته المرقعة الألوان، مع إضفاء للصفة الهزلية عليها، ودون تكبر على أي فقرة كانت، وذلك لأن عينه دائماً تكون على حيوية الخيمة وعدم تركها لتيار صقيع يأتيها من ثقوب زمنية ضعيفة بفعل أسنان فئران إنطلقت من محض صدفة تاريخية، ليتفاجأ حينئذ الجمهور بمدى أصالة مهاراته ومواهبه واجتهادته، ناهيك عن تكثيف مرحه عبر الإيجاز والإسناد في أي فقرة سيتولى تقديمها.
إنه فنان استثنائي يحيا داخل الخيمة، ولا يطيق الخروج منها، وإن خرج حملها معه ثم عاد إليها، إما أكثر مهارة، أو أكثر صقلاً، أو أكثر وعياً بفكرة السيرك. فنان سينتظره الجميع برغم ما قد يطويه في داخله من مشاعر وأحاسيس نحو حدث وزمان ومكان عالمه الدائري الصغير والواسع في آن.
قد تتعجب أيها القاريء من هذه المقدمة، وربما تتعجب أكثر من جرأة إلصاقي لاحقاً لنفسي بهذه الصفة، والتي قد تكون مثار تندر من البعض من يجلسون في الخيمة على مقاعد مجانية منحت لهم بطريقة ما ـ أحب أن أصفهم بالمتفرجين بالمجان ـ ودون امتلاك لحس متفرج سيرك أصيل، أو حتى رغبة أصيلة في أن يصبحوا لاعبي سيرك؛ فهم، في النهاية، ينظرون للحبل بأعلى ولا يمكن بأي حال، أن يكون لديهم استعمال أخر له سوى احكام غلق "كراتين" ثقافتهم الرثة! بل وقد يثير حفيظة بعض مثقفي اليسار أن أقول إن ثمة نقاط تماس ما بين مفهوم المهرج هذا وبين مفهوم جرامشي عن المثقف العضوي.
متى قررت ارتداء هذه البذلة ؟
أولاً، وقبل الإجابة، علي أن أوضح أنني لا أدعي هنا، بأي حال، أن هذه الصفة لصيقة بي وحدي؛ فثمة من يشاركني فيها في خيمة الثقافة السينمائية. وللتأكد؛ عليكم قراءة كتاب "حياة في السينما" للمثقف والناقد أمير العمري للتعرف على المجهود الذي بذل في السبعينيات من جانب النقاد والسينمائيين والذين كانوا في تعاضد نادر لضخ الحيوية في خيمة السينما المصرية. ولتفسير علاقتي بهذه الفترة علي أن أحيطكم علماً أيضاً بولهي في إكسسوار خاص ينتشر في منازلنا ولكنه يمثل أيضاً جزءا أصيلا من أية خيمة ثقافية سينمائية.
إنه .. الدولاب
وما جعله يلح على ذهني في الفترة الأخيرة كان الكتاب سالف الذكر، فقد استدعى هذا الكتاب ذكرياتي مع دولاب خاص كابي اللون وعتيق ويصعد حتى يلامس سقف خيمته، إنه دولاب نشرات سينما جمعية النقاد في مركز الثقافة السينمائية، والذي تحول في أواخر الثمانينيات أثناء تجولي بين سينمات وسط المدينة ومحال البسبوسة والآيس كريم إلى مزار، مثله في ذلك مثل دواليب مراكز ثقافة دول شرق أوروبا أو غربها أو الهند أو شرق آسيا أو أمريكا. كنت أزوره بشكل دوري حاملاً حقيبة ظهري لكي أغترف من خاناته الضيقة، والتي بدت وكأنها صنعت خصيصاً لتلك النشرات خفيفة الوزن والمستطيلة والصغيرة والمصنوعة من ورق رخيص مصقل قليلاً ومقسم لأعمدة لإتاحة مساحة كافية لأعمدة نقاد لم أتشرف بمقابلتهم ولو لمرة في عمر الشباب. كانوا جميعاً بالنسبة لي فقط أسماء هامة تساعدني على التحصل وعلى المعرفة السينمائية عبر أسماء وأعمال سينمائية لم أكن على صلة بها. وفي الأخير، والأهم، في التعرف على وجهة نظر ذلك الناقد في تركيبة كل ساحر سينمائي أعرفه. والآن، ومن خلال كتاب "حياة في السينما"، أدركت أن هذا الدولاب كان على زوال، وعرفت لماذا كان نهمي في الإستحواذ على أكبر كم من تلك النشرات التي توقف صدور المزيد منها، فقد قبعت خلفه شخصيات لها مواقف، وأخرى كان الصراع أقسى من أن تتحمله؛ فقد مرت بصراعات شخصية، وتناحرات، واحتواءات، واغراءات، وصدامات. وأن ذلك الدولاب كان يمثل لي أحد رموز تاريخ الثقافة السينمائية التي مرت بسطوة سلطة لا تريد لها الصيرورة وتعمل بحذق على فك وصلات ترابط هذا الدولاب.
لكن، لماذا لم يقدم أحد في التسعينيات على رتق ما أكلته الفئران في نسيج الثقافة السينمائية في مصر المحروسة؟ نعم مرت محاولات مخلصة في بث الروح فيها، مثل محاولة إعادة الروح لجمعية النقاد عبر مجلة "السينما الجديدة"، أو عبر جهد فردي من الممثل الموهوب موهبة استثنائية والمثقف والرجل المحترم محمود حميدة، والمتمثل في مجلة "الفن السابع"، والتي سعت لسد فراغ المطبوعة السينمائية المتخصصة، ولكنها أنهكت بمشاكل أعتقد أنها في مجملها تنتمي لسعيها الطموح نحو بريق سينمائي طباعي فاخر يعلن رغبة في أن تكون متخصصة وأن تمثل، في آن واحد، مجمل أطياف السينما حتى التجاري منها، مع أنها إذا كانت صدرت في أرخص شكل متخصص لكنا جميعاً تلهفنا عليها بذات التلهف منذ طبعتها التجريبية الأولى؛ فقد ضمت بين طياتها نقادا محنكين، وواعدين، وكتاب كلمة ينصت لهم.
والآن .. يجب أن أخرج السؤال الأول من ذلك الدولاب..
متى قررت ارتداء هذه البذلة ؟
إنه سؤال يجبرني علي أن أعود بذاكرتي إلى المرة الأولى التي لمست يدي فيها خامات المكياج أمام المرآة. وكان ذلك في أول محاضرة عملية للمكياج في المعهد العالي للسينما. أذكر أني، وبعد تعرفي على خطوات تشكيل وجه المهرج، جلست أمام مرآة غير مصقولة، وتقليدية في شكلها المزروع في ثلاثية، إطارها لمبات صفراء، متناوباً التحديق في خامات الأوان وفي وجهي تساؤل، عما يجب أن يكون عليه مهرجي، وأية خطوط ستمثله، هل سأستعيد خطوط وألوان مهرجي سيرك التلفاز، أم هل ستكون تلك الخاصة بممثلي الكابوكي والذين شاهدتهم في لمحة خاطفة في فيلم قديم، يا إلهي لقد كان من الأبيض والأسود!
أولئك الممثلون المذهلون الذين تعرفت على إبداعهم لاحقاً. أذكر أني صرخت وقتها: أين نصف كرة البنج تلك الخاصة بأنفي !!؟. لم يجبني أحد، بل وعلق استاذي وقتها بأن علي الإنتهاء سريعاً فقد اقترب ميعاد انتهاء المحاضرة، إلا أن ذلك لم يثنيني عن أن أختار، وبدقة، ذلك التحول من وجهي الطبيعي إلى وجهي الثاني؛ وجه "مهرجي".
نعم هناك أقنعة كثيرة نرتديها على مدار يومنا، إلا أن ما كان يجذب ذهني وقتها كانت تلك الأقنعة الأنثروبولوجية التي توالت على مدار تاريخ البشرية بتنوعاتها الثقافية والعرقية، ومن بين أكثر تلك الإقنعة إثارة لذهني كان قناعا الساحر والمهرج، واللذان قفزا بذهني أمام مرآة المكياج، الأول تتطور تركيبته ولا تتغير، وأرتديه منذ ميلادي، ثلثه إنسان وثلثه حيوان وثلثه الأخير فنان/ مخرج، إنه مزيج ثلاثي يتعارك دائماً في الخطوط والملامح. أما الثاني، وهو ما اقتنصته في هذه اللحظة، فقد كان قناع المهرج الغاضب على خيمة السينما؛ ففي وقتها كانت السينما المصرية في تراجع على مستوى الكيف والكم على حد سواء. حدقت في وجهي وأخذت أضع المادة الأساس، ثم بعنف حاد خططت الحزن والغضب على ملامحي.






 لا اعتذار
لا اعتذار صديقنا الممثل المصري الأصل الأمريكي الجنسية، الذي يعمل منذ سنوات في هوليوود يحقق نجاحات متتالية هناك. فقد تألق أخيرا في فيلم "الرجل الحديدي" وحصل على تقدير الكثيرين في دوره كتاجر سلاح. وقام بعد ذلك بالدور الثاني في "الربيع في خطوتها" الفيلم القادم للمخرج المستقل مايكل برجمان، ويلعب فيه دور سائق تاكسي فلسطيني، كما يقوم بدور سفاح في الفيلم المكسيكي من تمويل بارامونت بعنوان "الساحة الخلفية" وتقول المعلومات المنشورة عنه أنه يستند إلى قصة حقيقية، وهو من إخراج المخرج المكسيكي كارلوس كارييرا.
صديقنا الممثل المصري الأصل الأمريكي الجنسية، الذي يعمل منذ سنوات في هوليوود يحقق نجاحات متتالية هناك. فقد تألق أخيرا في فيلم "الرجل الحديدي" وحصل على تقدير الكثيرين في دوره كتاجر سلاح. وقام بعد ذلك بالدور الثاني في "الربيع في خطوتها" الفيلم القادم للمخرج المستقل مايكل برجمان، ويلعب فيه دور سائق تاكسي فلسطيني، كما يقوم بدور سفاح في الفيلم المكسيكي من تمويل بارامونت بعنوان "الساحة الخلفية" وتقول المعلومات المنشورة عنه أنه يستند إلى قصة حقيقية، وهو من إخراج المخرج المكسيكي كارلوس كارييرا. وقبل سنوات وتحديدا في 2002، عرضنا في إطار برنامج جمعية نقاد السينما المصريين وقت رئاستي لها، الفيلم التسجيلي الطويل الممتع "إنقاذ كلاسيكيات السينما المصرية" الذي انتجه وأخرجه سيد بدرية.
وقبل سنوات وتحديدا في 2002، عرضنا في إطار برنامج جمعية نقاد السينما المصريين وقت رئاستي لها، الفيلم التسجيلي الطويل الممتع "إنقاذ كلاسيكيات السينما المصرية" الذي انتجه وأخرجه سيد بدرية.
 لقطة من فيلم "الغاز الكائن البشري"
لقطة من فيلم "الغاز الكائن البشري"
ماكافييف الذي تجرأ على انتقاد الحزب والجمود السياسي والمذهبي في أفلامه الثلاثة الأولى التي سخر فيها كما يشاء من النظام، بل ودعا في فيلمه الأشهر "ألغاز الكائن البشري" The Mysteries of the Organism إلى الحرية الجنسية كوسيلة لتحرير المجتمع استنادا إلى نظريات العالم الألماني الشهير فيلهلم رايخ، انتهى بأن هاجر إلى الولايات المتحدة حيث قام بتدريس السينما لسنوات في كاليفورنيا، ثم صنع عددا من الأفلام منها "مونتنجرو" و"طفل الكوكاكولا" و"فيلم حلو" قبل أن يقدم آخر أفلامه المهمة وهو "الغوريلا" الذي عرض عروضا محدودة عام 1993. ولا نعرف ما هو مصير ماكافييف حاليا بعد أن تقدم في العمر. ربما لايزال يدرس السينما ويعيش على الماضي الذي كان.
سينما التجريب
كان ماكافييف، الذي درس علم النفس قبل أن يدرس السينما والتليفزيون، مهتما بالتجريب، وبخلق لغة جديدة، بصرية، يستخدم فيها أسلوب "الكولاج" الشائع في الفن التشكيلي. وقد وصل سينمائيا إلى السيريالية، وفكريا إلى الفوضوية أي التمرد على كل المؤسسات الاجتماعية ورفضها.
أما "الغوريلا تستحم عند الظهر" فهو فيلم درامي- تسجيلي، فيه ملامح كثيرة من أسلوب ماكافييف المعروف: تداخل السرد، الكولاج، التعليق الصوتي، استخدام مواد من الأرشيف، المزج بين الخيال والواقع، الاعتماد على لامنطقية الأحلام التي يمزجها أيضا بالهواجس الشخصية بالواقع، وتوليد الضحك من الماساة. لكن الفيلم رغم ذلك، تشيع فيه لمسة من الحزن والرثاء لعصر كامل ولي، ومفاهيم زالت، ولم يبق منها سوى رأس لتمثال مقطوع للزعيم الشيوعي فلاديمير التيش (لينين) الذي ألهم الملايين في الماضي وحتى الماضي القريب. هل عاد ماكافييف بعد زوال العصر السوفيتي للترحم على ذلك العصر؟
يعتمد الفيلم على الممثل الواحد الذي يروي القصة في سياق أشبه بـ :المونولوج". إنه جندي في الجيش السوفيتي الأحمر السابق، كان متمركزا مع القوات السوفيتية في ألمانيا الشرقية السابقة، وقد ادخل المستشفى في وقت ما لتلقي العلاج. وعندما غادرها وجد أن جيشه قد رحل وتركه في الخلف، الأمر الذي اعتبره نوعا من "الخيانة" الشخصية له، هو المخلص كل الإخلاص للقيم والمبادئ الايديولوجية التي تربى عليها الجيش الأحمر. لقد هرب جيش كامل من الخدمة تاركا وراءه جنديا واحدا متمسكا بأداء الواجب.
يستمر الجندي، ويدعى فيكتور بورسيفيتش، في القيام بواجبه، محافظا على زيه العسكري الرسمي اللامع، رافضا قبول فكرة أن كل ما ناضل من أجله طيلة حياته قد انتهى. إنه ابن ذلك البطل القومي السوفيتي الذي كان أول من رفع العلم الأحمر فوق مبنى الريشتاغ الألماني (البرلمان) في قلب برلين بعد دخول القوات السوفيتية ودحر النازيين عام 1945.
التداعي والواقع
في النصف الأول من الفيلم يستخدم ماكافييف لقطات من الفيلم السوفيتي التسجيلي الشهير "سقوط برلين"، وهو من كلاسيكيات المرحلة الستالينية في السينما السوفيتية: لقطات للجموع في تحية القائد ستالين أمام الكرملين، لقطات لدخول الجنود السوفيت إلى برلين.. هذه اللقطات تتداعى دائما في مخيلة بطلنا الجندي وهو يواجه مصيرا آخر عبثيا تماما.

يقبضون عليه ويودعونه السجن لفترة، ثم يطلقون سراحه ويعطونه بطاقة سفر لكي يعود إلى بلاده، إلا أنه يبيعها مقابل حفنة من الماركات سرعان ما تنفد فيلجأ إلى سرقة بعض الفاكهة حتى لا يموت جوعا.
يستمر في التجوال حتى يصل إلى منطقة خرائب خارج المدينة، يتخذها المتسولون والهائمون على وجوههم منطقة تجمع لهم بعيدا عن عيون القانون. يقيم علاقة بفتاة ضائعة.. يعثر على طفل رضيع ماتت أمه بعد أن شب حريق في منزلها أتى عليه تماما، يلتقط الطفل، ويعطيه للفتاة التي ترغب في تبنيه، يأتي تاجر من تجار السوق السوداء في زمن الانهيار، يعرض عليه مبلغا مغريا مقابل الحصول على الطفل. يتردد صاحبنا طويلا، لكنه يضطر للرضوخ تحت وطأة الإحساس بالجوع.
 لقطة من فيلم "حياة الآخرين"
لقطة من فيلم "حياة الآخرين"